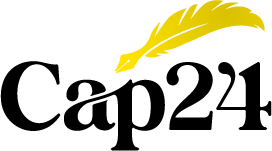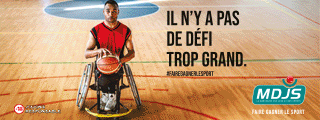علم الاجتماع.. من فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية إلى صناعة المجتمع
رشيد فحصي، طالب بسلك الماستر، جامعة ابن طفيل القنيطرة
بعد الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر، ركز علماء الاجتماع المؤسسين على تفسير كيف تؤثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية على السلوك البشري وعلى بناء المؤسسات الاجتماعية معتمدين في ذلك على مناهج دقيقة (المناهج الكمية)، مؤكدين على دراسة الظواهر الاجتماعية كأشياء. لكن التقدم الذي عرفته المجتمعات البشرية والمعرفة العلمية بالخصوص، رافقه تقدم على مستوى الفكر السوسيولوجي أيضا، حيث ذهب علماء الاجتماع -إلى جانب تفسير الظواهر الاجتماعية- إلى فهم كيفية تأثير الأفراد على المجتمع، وكيف يمكن لتفاعلات الأفراد أن تعيد تشكيل هذا المجتمع. الأمر الذي وجه العمل السوسيولوجي صوب الميدان بمقاربات منهجية جديدة (المناهج الكيفية) معيدين النظر في موضوع علم الاجتماع الذي هو الظاهرة الاجتماعية، فبعد أن كانت هذه الأخيرة مستقلة عن شعور الأفراد، وأنها تمارس نوعا من القهر والإلزام على الفرد (الأمر الذي يجعل منها شيئا موضوعيا مستقلا عنه ؛ أي لا تتأثر بغيابه أو وجوده كذات)، صارت الظاهرة الاجتماعية مع مدرسة شيكاغو (التي شكلت منعطفا جديدا في تاريخ علم الاجتماع) ” هي ضرب من التركيب الحميمي بين القيم الاجتماعية (الموضوعية) والمواقف الفردية (الذاتية)، أي أنه لا يمكننا دراستها كما ندرس الظواهر الطبيعية، وذلك لأن السببية الاجتماعية معقدة وينبغي أن تتضمن في الوقت نفسه عناصر موضوعية وذاتية وقيم ومواقف”[1]. إن إخراج السوسيولوجيا من المكاتب إلى الميدان ساهم في بلورة مجموعة من الفروع التي تفرعت من علم الاجتماع العام، حيث صارت هناك سوسيولوجيا الهجرة، التنظيم، الحضرية، القروية، الصحة، التنمية …إلخ وفي هذا الفرع الأخير انصب اهتمام علماء الاجتماع حول ثنائية التنمية والتخلف، حيث اتجهوا في ذلك اتجاهات مختلفة في تفسير وفهم التنمية.
إن التراكم المعرفي الذي حصل على مستوى سوسيولوجيا التنمية، جعل من التفكير السوسيولوجي آلية مهمة وضرورية لكل عملية تنموية في إطار ما أصبح يطلق عليه بـ “المقاربة السوسيولوجية” باعتبارها “محاولة من أجل التدخل من خلال اعتمادها على المناهج الملائمة التي يمكن أن تسهم في تقديم مقترحات تفسيرية بغرض إيجاد حل مقبول لظاهرة أو مشكلة اجتماعية أُثيرَت في المجتمع، وهي تسعى إلى تنظيم الظاهرة وآليات اشتغالها وأشكال تطورها والتأثيرات التي تحدثها”[2]. إن الاعتماد على السوسيولوجيا في مسألة التنمية لم يكن نتيجة للصدفة، بل فرضته شروط موضوعية وذاتية كشفت عن قصور المقاربة التقنية التي لا تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات موضوع الدراسة. ولتوضيح أهمية الاشتغال على ما تتجاهله المقاربة التقنية (الاحتياجات والقيم والمعتقدات المحلية) نستحضر المثال التالي: رصد البنك الدولي لفائدة دولة النيجر سنة 1985 أموالا طائلة من أجل تنفيذ مشروع غايته زراعة أشجار الأوكاليبتوس وإنتاج الخشب الموجه للاستعمال من أجل تثبيت أعمدة الكهرباء والهاتف السلكي (…) حيث عمل المشروع على إعادة تشجير مساحات شاسعة تقدر ب 10000 هكتار على ضفاف نهر النيجر (…) على المستوى النظري كانت الدراسة تؤكد إنتاج الخشب والعود سيصل إلى 25 متر مكعب في الهكتار بعد ست سنوات (…) لكن بعد أول محطة تقييمية للمشروع كانت الخيبة كبيرة، حيث لم تبلغ المردودية سوى 1.6 متر مكعب من الخشب للهكتار الواحد. (…) فبعد الإقرار بفشل المشروع في تحقيق الجدوى من ورائه، سيتم العمل على تحويل وجهته صوب استغلال أشجاره من طرف المجتمع المحلي عن طريق استغلال الأعواد في الاستعمالات المنزلية اليومية كالطهي (حيث كان السكان يعتمدون على الفحم الخشبي والحطب في إعداد الطعام). لكن المفاجأة الكبرى (أو بالأحرى الصدمة الكبرى) هي رفض النساء الريفيات بالنيجر استعمال هذه الأخشاب لأنها تنتج رائحة مزعجة وأدخنة كثيفة[3]. وبالتالي فشل المشروع اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لأن تنفيذه لم يأخذ بعين الاعتبار رغبة السكان المحليين في استنبات هذا النوع من الأشجار ومدى استحسانهم لنوعيته وتكامله مع نمط عيشهم[4].
إن هذا الارتباط بين علم الاجتماع وبين التنمية فرض واقعا جديدا والمتمثل في ضرورة حضور العلوم الاجتماعية في المرجعيات المعرفية داخل المؤسسات المهتمة بالتنمية، مما فتح الباب أمام انخراط الباحثين السوسيولوجيين والأنتروبولوجيين في إنجاز دراسات وأبحاث لصالح هذه المؤسسات والمنظمات في إطار دراسات الخبرة (خاصة في ظل تقليص ميزانية البحث العلمي بالجامعات ، وإغراءات المؤسسات الراعية للخبرة)، لدرجة أصبحت الفجوة منعدمة بين الباحث الأكاديمي والخبير خاصة في الاتجاه الأنجلوسكسوني حيث صار الباحث الأكاديمي يحمل بذلتين؛ بذلة الباحث وبذلة الخبير على حد تعبير الدكتور نور الدين لشكر، الأمر الذي نتج عنه نقاش داخل الوسط الأكاديمي بين مؤيد ومعارض للعمل في هذا الإطار[5].
إن إقحام السوسيولوجيا في إعداد وتخطيط المشاريع التنموية، نقلها من مرحلة تفسير وفهم الظواهر الاجتماعية إلى صناعة المجتمع، بمعنى الانتقال من سؤال لماذا وكيف تحدث الظواهر الاجتماعية إلى كيف يمكن للسوسيولوجيا أن تؤثر في تشكيل وتوجيه المجتمع من خلال برامج ومشاريع تدخلية، حيث يرى فرنسوا ديبي (François Dubet) ” أن علم الاجتماع لم يعد علم المجتمع، بل أصبح علم آلاف طرق صنع المجتمعات”[6] الأمر الذي يمكن اعتباره تحولا جديدا في مسار علم الاجتماع.
وفي هذا الصدد يرى الدكتور نور الدين لشكر “أن العديد من السوسيولوجيين يعتبرون أن هذا التحول في النموذج سيغير العلاقة بين الإنسان والعلم بعمق، ويبدو دور الخبير مهم وأخطر من ذي قبل، حيث يُلقى على عاتقه إعادة النظر في العلاقة بين القيم والعلوم، وهو ما يتطلب منه إبداعا عقليا لرسم معالم واقع مفترض جديد، قد يبعده عن الموضوعية والحيادية التي هي شرط أخلاقي في العلم، أو على الأقل توقع نتائج تلك التحولات بعد رصدها من خلال خبرته”[7].
إن هذا الواقع يضعنا أما سؤال جوهري: هل سيتحول علماء الاجتماع إلى مهندسين اجتماعيين (يقودون المجتمع نحو مسار معين) أم سيستمرون في دورهم كمدافعين عن الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية واستقلالية العلم عن أي جهة سياسية أو إيديولوجية، مسلحين بالإرث السوسيولوجي النقدي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى الحديث عن نوعين من الخبراء؛ خبراء تقنويون ممتثلون لتوجيهات وأهداف الجهة الراعية للخبرة وخبراء مبدعون، بالنسبة للنوع الأول لا يهمهم إلا إنجاز تقاريرهم كما تم الاتفاق عليه، حاملين معهم معداتهم التقليدية (آلات التصوير، مسجل صوتي، تطبيقات رقمية …) دون الدخول في التفاصيل والحيثيات التي تكمن خلف تلك البرامج والمشاريع التدخلية، أو مساءلة جدواها وتتبع آثارها، كما أن مهمتهم تنتهي بتسلم أجرتهم المتفق عليها. أما بالنسبة للخبراء المبدعين هم الذين ينزلون للميدان وهم مسلحون بمعداتهم السوسيولوجية (الشك، النقد، التساؤل، الموضوعية …)، كما أنهم يتعاملون مع الواقع كما هو وليس كما تريده أو تراه الجهة الراعية لخبرتهم، ملتزمون في ذلك الحد الأدنى من الحياد والموضوعية، فهذا النوع من الخبراء يجعلون من خبرتهم مشروعا علميا جديدا يطورون من خلاله معرفتهم وحسهم السوسيولوجي، إضافة إلى تحيين معطياتهم حول القضايا التي يشتغلون عليها، الشيء الذي يصعب تحقيقه بإمكانياتهم الذاتية خاصة أمام هزالة الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالجامعات.[8]
إن الخبرة بقدر ما هي ضرورية للمجتمع بقدر ما أنها يمكن أن تشكل خطرا عليه (إذا لم يلتزم الخبير الموضوعية والحياد العلمي) من خلال فرض سياسات على الشعوب -يتم تغليفها بغطاء علمي من قبيل توصلت دراسة علمية… أو تنصح دراسة علمية …- من طرف لوبيات معينة تتوفر على إمكانيات مالية لا يستهان بها (خاصة في الدول التي لا تتوفر على مكاتب دراسات تمولها من ميزانياتها) حيث قد تتسلل أفكار هذه اللوبيات إلى قرارات واختيارات الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عن طريق مكاتب الدراسات الخاصة، أو من خلال التعاقد مع مكاتب دراسات غير مهنية؛ أي لا تحمل من الصفة إلا الاسم (الخبرة الهشة كما سماها الدكتور نور الدين لشكر). وهذا ما يجد تبريره في العديد من الاختيارات التي سعت العديد من الدول إلى تنفيذها -بناء على دراسات أنجزتها مراكز دراسات خاصة- ضدا على إرادة شعوبها، الأمر الذي ينتج عنه في الغالب حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي قد تكون نتائجها عكسية على تنمية البلد.
وبالتالي فالخبرة في العصر الراهن يمكن أن نطلق عليها وصف، ظاهرة العصر إن صح القول، إذ أن نتائجها أصبحت تخترق نقاشات الأفراد والمنظمات والمؤسسات بوعي أو بدونه، حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإطارات السياسية أو الهيآت النقابية أو الجمعوية، التي تتبنى مواقف ضد المؤسسات المالية المانحة (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي …)، تستعمل في خطابها اليومي مع منخرطيها أو مع عموم الشعب مصطلحات ومفاهيم من إنتاج الخبرة التي أنتجتها تلك المؤسسات المانحة والتي توظفها في تقاريرها وتروجها إعلاميا … وبالتالي فرغم تصور الفرد نفسه مستقلا وأنه يساهم في القرارات التي تتخذها حكومته، إلا أنه “خاضع لقواعد الخبرة والتي صارت أداة جديدة للسيطرة الاجتماعية”[9].
[1] عبد الرحمن المالكي، مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، أفريقيا الشرق، ط. 2، ص 102
[2] محمد المرجان، سوسيولوجيا الخبرة والخبراء، مركز نماء للبحوث والدراسات، ص 5
[3] نور الدين لشكر، عمار حمداش، في الخبرة والتنمية، سيرة خبير دولي يوسف ثابت، دار القلم، ط.1 ،2022 ص 209، ص 211
[4] نفس المرجع السابق ص 210
[5] للمزيد من التفصيل انظر كتاب نور الدين لشكر ” في سوسيولوجيا الخبرة والخبراء”، وذلك قصد الاطلاع على مواقف الباحثين الذين أجرى معهم الباحث مقابلات تخص الموقف من الخبرة
[6] نقلا عن نور الدين لشكر، في سوسيولوجيا الخبرة والخبراء، دار القلم، ط 2، ص 113
[7] نفس المرجع السابق ص 114
[8] للمزيد من التفصيل انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث من كتاب في سوسيولوجيا الخبرة والخبراء، ثم مقال العلوم الاجتماعية بين الباحث والخبير، أوجه التشابه والاختلاف، للدكتور نور الدين لشكر.
[9] إدريس أيتلحو، تقديم لكتاب في سوسيولوجيا الخبرة والخبراء، ص 12