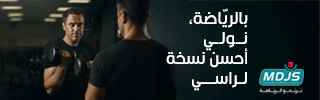الكارح ابو سالم
في اللحظة التي تتحول فيها خزينة الدولة إلى ربّ العمل الفعلي للصحافيين، لا تعود الأسئلة بريئة، ولا يصبح النقاش تقنيًا أو اجتماعيًا. نحن أمام تحوّل بنيوي يمس جوهر الصحافة نفسها: استقلالها، جرأتها، وقدرتها على مراقبة السلطة بدل الدوران في فلكها.
للسنة الخامسة على التوالي، تواصل وزارة الاتصال صرف أجور الصحافيات والصحافيين مباشرة في حساباتهم البنكية عبر صندوق دعم الصحافة. إجراء وُلد كاستثناء خلال جائحة كوفيد-19، لكنه تحوّل، بلا نقاش عمومي ولا تقييم مؤسساتي، إلى قاعدة تدبيرية دائمة، تُدار بها علاقة شغلية يفترض أن تكون بين الأجير والمقاولة، لا بين الصحافي والوزارة.
هنا لا نتحدث عن دعم عابر، بل عن إعادة هندسة صامتة لموازين القوة داخل الحقل الإعلامي. فالذي يدفع الأجر، يملك – موضوعيًا – سلطة التأثير، ولو بدون أوامر مكتوبة. ومن يملك سلطة التأثير، يُعيد تلقائيًا رسم حدود ما يُقال، وما يُؤجَّل، وما لا يُكتب أصلًا.
الأخطر أن هذا النموذج فتح الباب لاختلالات فجّة: تضخيم كتل الأجور، إدراج أسماء أقارب في لوائح الدعم، أجور شهرية لمدراء مقاولات تجاوزت أجر الوزير الوصي نفسه، وكتل أجور فاقت 90 مليون سنتيم شهريًا، دون أي ربط بالإنتاج، أو الجودة، أو التأثير، أو أخلاقيات المهنة. دعم بلا محاسبة، ومال عمومي بلا حكامة.
أي مقاولة إعلامية هذه التي لا تنتج أرباحًا، ولا تبحث عن موارد، ولا تتكيف مع التحولات الرقمية، ثم تطالب الدولة بتمويل رواتبها؟
وأي صحافة ننتظر من مؤسسات تعيش على الإنعاش الاصطناعي، وتُدار بعقلية الماضي، بينما تُظلِم معها مئات الصحافيين، وتُفرغ المهنة من معناها؟
الدفاع عن هذا الوضع بشعار “حماية مناصب الشغل” يبدو إنسانيًا في ظاهره، لكنه يخفي مفارقة قاتلة: إنقاذ الجسد على حساب الروح. فما قيمة راتب منتظم إذا كان ثمنه الصمت؟ وما قيمة مؤسسة مستقرة ماليًا إذا فقدت الجرأة على مساءلة من يمولها؟
الرقابة هنا لا تُمارَس بالقانون، بل بالميزانية.
عنوان يُخفف، تحقيق يُؤجَّل، سؤال يُستبدل بآخر أقل إزعاجًا. لا حاجة للتدخل المباشر، فالتدجين يتم ذاتيًا، وبهدوء، وباسم “التوازن” و“القراءة السياقية”. هكذا تُصنع صحافة بلا أنياب.
ثم تأتي أزمة الثقة. الجمهور ليس غبيًا. حين يعلم أن المنبر الذي يطالعه ممول من الجهة التي يُفترض أن يراقبها، تتآكل المصداقية. ومع تآكل المصداقية، تفقد الصحافة سلاحها الوحيد: ثقة المواطن. عندها لا تعود سلطة رابعة، بل واجهة مزخرفة في مشهد ديمقراطي هش.
الأكثر خطورة أن الوزير الوصي، وهو الممول، يسعى في الآن نفسه إلى التحكم في الإطار التنظيمي للمهنة، من خلال قوانين المجلس الوطني للصحافة، التي اصطدمت بملاحظات المجلس الدستوري. كيف يمكن الحديث عن تنظيم مستقل، في ظل وصاية مالية وتشريعية مزدوجة؟ وكيف يُنتظر من مجلس يُرعى سياسيًا وماليًا أن يكون حكمًا محايدًا؟
الحل لا يكمن في تجويع الصحافة، ولا في تركها للإفلاس، بل في تحريرها فعليًا:
دعم عمومي مؤطَّر بقواعد صارمة، صرفه للمقاولات لا للأفراد، ربطه بالإنتاج والجودة، إشراك المهنيين الحقيقيين في لجان الدعم، تفعيل الاتفاقية الجماعية، وبناء نموذج تمويل يسمح للمقاولة الإعلامية بأن تمول نفسها بنفسها، لتكسب الهامش الضروري للنقد والمساءلة.
فالصحافة ليست صدقة اجتماعية، ولا ملحقة إدارية. هي ركيزة من ركائز الديمقراطية. وإذا استمرت تُدار بهذه الكيفية، فلن تغادر مكانها، ولن تنتج سوى ضجيج بلا أثر.
السؤال اليوم ليس فلسفيًا ولا نظريًا:
عندما تدفع الحكومة الرواتب، من يجرؤ على مساءلتها غدًا؟
إنها معادلة بسيطة وخطيرة: من يدفع… يُسكت. وإذا سُكتت الصحافة، خسر المجتمع آخر خطوط الدفاع .