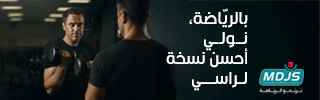الگارح ابو سالم
حين يُصرّ حفيظ الدراجي على اختزال مسار المنتخب المغربي في عبارة تهكمية من قبيل أن “الضغوطات طبيعية لأنه لم يفز بكأس إفريقيا منذ خمسين سنة”، فإنه لا يقدّم تحليلًا بقدر ما يهرب إلى تبسيط مخلّ، يتجاهل السياق، ويقفز فوق الوقائع، ويُفرغ نصف قرن من التعقيدات القارية التي واجهت كرة القدم المغربية ،في جملة عابرة تصلح للتدوينات التي تنفت سما ، أكثر مما تصلح للتحليل الإعلامي المسؤول. فمعاناة المنتخب المغربي في إفريقيا لم تكن في جوهرها نتيجة ضعف تقني أو عجز كروي، بل كانت في محطات كثيرة نتاج وضع غير متكافئ، فرضته طبيعة التسيير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انذاك، حيث لا تُدار اللعبة باللوائح المكتوبة فقط، كما هو الشأن في أوروبا، بل تتداخل فيها التوازنات السياسية، والتحالفات داخل المكتب التنفيذي، والنفوذ الجغرافي، ومنطق “المعاملة بالمثل”.
وخلال فترات طويلة، خاصة بين أواخر التسعينيات وبداية العقد الثاني من الألفية، كان المغرب ضعيف التمثيل أو غير ممثل أصلًا داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وغائبًا عن لجان التحكيم والانضباط والبرمجة والتنظيم، وهو ما جعل المنتخب الوطني يدخل عددًا من تنقلاته القارية مكشوف الظهر، بلا حماية مؤسساتية، في وقت كانت فيه منتخبات أخرى تستفيد من شبكة علاقات تضمن لها الحد الأدنى من الإنصاف، وأحيانًا أكثر من ذلك.
هذا الغياب لم يبقَ حبيس المكاتب، بل تُرجم ميدانيًا في أشكال متعددة من المضايقات. فقد عانى المنتخب المغربي مرارًا من تحكيم غير متوازن، تجلّى في أخطاء متكررة خلال مباريات حاسمة، وتساهل مفرط مع الخشونة ضد لاعبيه، وقرارات مؤثرة في لحظات مفصلية من ركلات جزاء وطرد وأهداف ملغاة. ولم يكن الإشكال في الخطأ التحكيمي المعزول، لأن الخطأ جزء من اللعبة، بل في تكراره، وفي غياب أي مساءلة لاحقة، وفي تجاهل شكاوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما كان يُقرأ داخل الأوساط الرياضية على أنه نتيجة مباشرة لغياب سند داخل دوائر القرار التحكيمي في الكونفدرالية الإفريقية.
وإلى جانب التحكيم، واجه المنتخب المغربي ظروف استقبال بعيدة عن الروح الرياضية في عدد من الدول الإفريقية، حيث تحولت الإقامة إلى معاناة حقيقية، من فنادق دون الحد الأدنى من الشروط، إلى تغييرات مفاجئة في مواعيد التداريب، وإغلاق الملاعب في وجه الحصص الإعدادية، وصولًا إلى التشويش الليلي المتعمّد عبر الضجيج والتجمعات الجماهيرية. وهي ممارسات يعرفها الجميع داخل القارة، غير أن الفرق كان واضحًا بين من يملك نفوذًا داخل الاتحاد الإفريقي فيُحمى، ومن لا يملكه فيدفع الثمن كاملًا.
كما انعكس غياب المغرب عن مراكز القرار على برمجة المباريات، إذ فُرضت عليه في أكثر من مناسبة مباريات في توقيتات مناخية قاسية، وسفر مرهق دون فترات راحة كافية، وخوض مواجهات حاسمة بعد تنقلات طويلة ومستنزِفة، في حين كانت منتخبات أخرى تستفيد من تعديلات سريعة، أو تأجيلات مرنة، أو إعادة جدولة عند أدنى احتجاج، ما كشف بوضوح ازدواجية المعايير داخل الجهاز القاري.

ولم يكن العنف الجماهيري بدوره استثناءً، إذ سُجلت حالات رشق بالحجارة، واقتحام لمحيط غرف الملابس، وتهديدات لفظية وضغط جماهيري غير مضبوط، غير أن الأخطر من كل ذلك كان في كون تقارير الحكام والمراقبين لا تعكس دائمًا حقيقة ما جرى، لتبقى العقوبات، إن فُرضت، شكلية وغير رادعة، وهو ما رسّخ لدى المتابع المغربي قناعة بأن المنتخب كان يُترك وحيدًا في الميدان.
هذه الأجواء كان لها أثر مباشر نفسيًا، حيث عاش اللاعبون توترًا دائمًا وفقدانًا للتركيز وشعورًا بالاستهداف، كما أثّرت رياضيًا عبر إقصاءات مبكرة وضياع مباريات خارج الميدان رغم التفوق التقني، وفشل في تحقيق استمرارية قارية، وأثّرت استراتيجيًا على صورة المغرب كقوة إفريقية في تلك المرحلة، وعلى الثقة في عدالة المنافسة داخل القارة.
ومع ذلك، ورغم كل هذه الظروف، استطاعت كرة القدم المغربية عبر أنديتها أن تفرض نفسها قارّيًا وتحقق ألقابًا وإنجازات كبيرة، وهو ما يفضح زيف أطروحة “العجز” التي يلمّح إليها الدراجي، ويطرح سؤالًا بسيطًا: كيف لبلد يُفترض أنه عاجز قاريًا أن يكون رقمًا صعبًا على مستوى الأندية؟
الأهم من ذلك أن المغرب، بدل البكاء على الأطلال أو الاختباء خلف الأعذار، قام بتشخيص عميق لوضعيته، انطلاقًا من المناظرة الوطنية للرياضة التي جاءت بتعليمات ملكية، مرورًا بتغييرات جذرية داخل الجامعة الملكية لكرة القدم، وإرساء سياسة الأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية محمد السادس، ثم العودة القوية إلى معترك الكونفدرالية الإفريقية كقوة اقتراحية تُسهم في صياغة القرارات بدل الاكتفاء بتلقيها.
ومنذ منتصف العقد الثاني للألفية، تغيّر المشهد فعلًا، فعاد المغرب إلى اللجان والمكتب التنفيذي، وفرض حضوره في ملفات التنظيم والتخطيط، واستثمر بذكاء في البنية التحتية والديبلوماسية الرياضية، لتكون النتيجة تراجعًا واضحًا للمضايقات، وتحسنًا في التحكيم، واحترامًا أكبر للبعثات المغربية، واعترافًا بالمغرب كشريك لا يمكن تجاوزه.
أما حديث الدراجي عن أن “القرعة ستفسح المجال للمغرب للفوز هذه المرة”، فليس سوى محاولة لتبخيس مشروع متكامل وتحويل مسار إصلاحي طويل إلى ضربة حظ. المغرب لا يراهن على القرعة، بل على رؤية، وتراكم، وعمل مؤسساتي أثبت نجاعته، في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وإلى تتويجات المنتخبات السنية ومنها فوز منخب الشبان بكأس العالم لأقل من عشرين سنة ، والفوز بالشان، والكاس العربية اخيرا ك وتوالت الإنجازات التي جعلت من المغرب ظاهرة كروية يُصفق لها العالم، وصولًا إلى شرف استضافة كأس إفريقيا وكأس العالم، وملاعب وبنيات تحتية كسرت القاعدة الإفريقية.
هذا هو المغرب، لا كما يُقدَّم في سخرية تدوينة، بل كما تصنعه الوقائع. ومن لا يُدافع عن نفسه إداريًا، سيدفع الثمن رياضيًا، أما من فهم الدرس واشتغل على تصحيحه، فسيُحسب له ألف حساب، داخل الملعب وخارجه